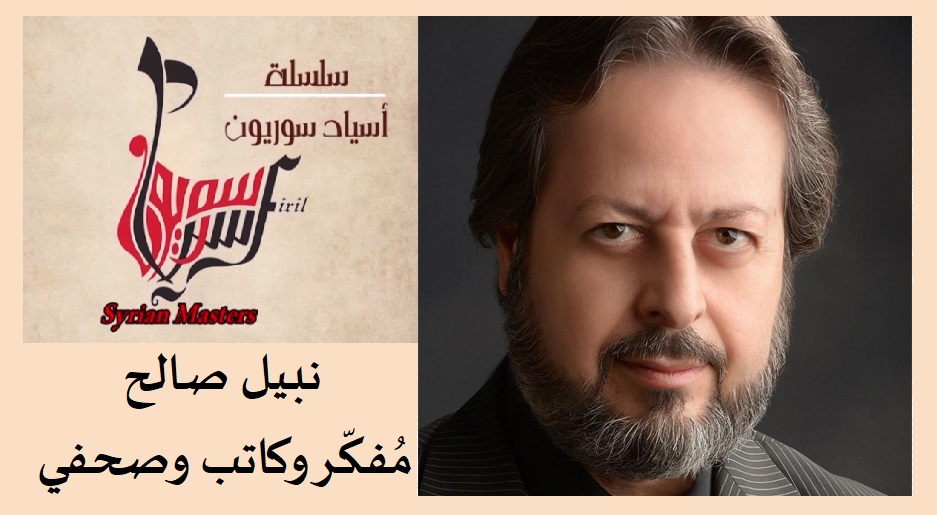
الدين الإبراهيمي الجديد في الشرق الأوسط. الكاتب والمُفكّر نبيل صالح. 24 أيلول 2021. مركز فيريل للدراسات، عدد القراءات 709816
الإبراهيمية؛ هي الدين السياسي الجديد في الشرق الأوسط، برعاية واشنطن وتل أبيب والأمم المتحدة والفاتيكان، وتعاون آلاف رجال الدّين ممن يعملون بالسياسة و”البزنس”. بالطبع ينقسمُ الناس حوله، فينكرُهُ المتشددون دينياً والعلمانيون والممانعون، ويدخلُ فيه دعاةُ السَّلام والمستثمرون والمنافقون وأنصافُ العلمانيين.
الإبراهيمية ليستْ بالدين السيء من ناحية جمع المشتركات بين الأديان الإبراهيمية الثلاثة، وإهمالَ دعوات العنف والتمييز العنصري وكراهية الآخر، التي تتضمنها الكتب المقدسة
بالمقابل؛ الإبراهيمية ليست بالدّين الجيّد من حيث أنه يعيد إنتاج الماضي المتخلف، بعدما قطعت الأمم أشواطاً في العلمانية والمواطنة، في ظل القوانين المدنية التي تساوي بين الناس في الحقوق والواجبات، غير أنّ الدين الإبراهيمي الجديد سيكون كلمة سلام تخفي العدوان على الحقوق العربية، وتمنع عودة أراضيها المحتلة، وتساعد على الاندماج الإسرائيلي–العربي، مع تدويل القدس كمدينة عالمية مقدسة وحل الدولتين
الدين الإبراهيمي الجديد، حسب مهندسيه، يجب أن ينتشر كما انتشرت الأديان الإبراهيمية القديمة، كونه ديناً توحيدياً مؤكداً لها، يحتفي بالوصايا العشر الواردة في ألواح موسى والمسيح ومحمد. كما أن منافع الإبراهيمية الاقتصادية والسياسية و “السياحية” ستستقطبُ الناسَ والحكوماتِ المنضويةَ تحت جناح الغرب الإمبريالي، فهو دين إمبريالي جديد سوف ترتقي حمايته إلى مستوى تهمة معاداة السامية لكل من يهاجمه. هذا تصورنا للأمر بعد تحليل التفاصيل المتعلقة بنشوء وانطلاق “الإبراهيمية الجديدة” في ظل “اتفاقات إبراهيم” للتطبيع العربي_الإسرائيلي
الأديان الإبراهيمية
نشأت الديانات الإبراهيمية الثلاث اليهودية والمسيحية والإسلامية في منطقتنا، حاملةً ثقافات شعوبها الرعوية والزراعية المتأثرة ببعضها، وبالتالي فهي تحمل مشتركات ومتناقضات الشعوب القديمة، وهو أمر ظاهر في أسفار وآيات كتبها المقدسة، حيث تستخدم المتناقضات العقيدية التي تبيح تكفير الآخر، وحتى وجوب قتله في حالات الصراع والتنافس بين بعضها، بينما تستخدم المشتركات وقت السلم حيث تقول أن جميع البشر إخوة؛ وعندما يستخدم المتدين “عقله” ويسأل عن سبب هذه المتناقضات بين الكتب، وحتى مع نفسها، يسكتهم رجال الدّين بالقول:
لحكمة لا يدركها إلا الله! فقد تسببت متناقضات الديانات الإبراهيمية والإختلاف على التأويل بكثير من الحروب والأحقاد والانقسامات الاجتماعية والمجازر الجماعية في المنطقة والعالم.
تذكر كتب التاريخ أنّ أتباع الديانات الإبراهيمية احتلوا مدينة القدس كل بدوره عدة مرات، وعانى المقدسيون طوال ثلاثة آلاف عام وصولاً إلى الاحتلال الإسرائيلي لها عام 1948، حيث خرَّبوا على العرب نموَّ العلمانية وبناء دولة المواطنة، إذ حرضت يهودية الدولة الإسرائيلية الإسلاموية العربية، وأعادت بلدان المنطقة إلى ما كانت عليه أيام الاحتلال العثماني، ليتطور الصراع من يهودي-إسلامي، إلى إسلامي إسلامي، بحيث تمكنت “إسرائيل من اختراق غالبية الدول العربية وتحويل الصراع ضد إيران بحجة مواجهة الخطر الشيعي؟!
الدين الإبراهيمي الجديد في الشرق الأوسط. الكاتب والمُفكّر نبيل صالح. 24 أيلول 2021. مركز فيريل للدراسات. تشكل الحكايات حياة الشرقيين، حيث الرواة أنبياء، والرسالة تأتي بصيغة حكاية لا يسمح بالتشكيك فيها أو مناقشتها منطقياً. أغلب الحكايات اليهودية معتمدة في الديانات الإبراهيمية التالية لها، وبعضها موجودة في تراث شعوب المنطقة البابلية والسومرية والفارسية والهندية، كحكاية الإله الذي يصارع نقيضه (الشيطان)، وقصة الطوفان، والخلق، والأفعى والخلود، والبطل الذي يقتل التنين وينقذ الصبية منه، والصابر أيوب، ويونس الذي بلعه الحوت لأيام ولم يهضمه. ذلك أن الفكر الديني نشأ في بلاد الرافدين وتطور عبر مئات القرون وصولاً إلى فكرة التوحيد التي عرفها الفراعنة قبل مجيء موسى بزمن بعيد. مع التنويه بأن أحداث التوراة وحكاياته لم يأتِ ذكرها في كتابات المؤرخين المعاصرين لها، كما لم تستطع البعثات الأثرية في فلسطين تأكيدها طوال مئة عام من التنقيب.
أما قصة إبراهيم الخليل جدِّ الأنبياء الموحدين، فلم يتمَّ تأكيدها علمياً حتى الآن، لتنشأ عند علماء التاريخ العديد من الأسئلة: فلو أنه جد العرب فكيف حدث وأنهم من بعده كانوا يعبدون الأصنام في كعبة إبراهيم محطم الأصنام الداعي إلى وحدانية الخالق! بل كيف يكون جد العرب وقد جاء من بلاد غير بلادهم (من حران شمال سورية)؟ وما الذي دفع إبراهيم للارتحال عكسياً مع عائلته من الفرات حيث الماء والكلأ إلى فلسطين فمصر فالحجاز حيث القحل وشحُّ الأمطار وانتفاء الأنهار والصراع بين القبائل على بقعة المرعى، القبائل العربية التي كانت ترحل دائماً نحو الشمال حيث الماء والكلأ؟! وكيف تلد امرأته العاقر هاجر بعدما تجاوزت الستين من عمرها بينما زوجها العجوز مشغول بجاريتها سارة؟! وهل يعقل أن شبه الجزيرة كانت فارغة خلال مليون عام مضت حتى مجيئه وبذر سلالته فيها؟ وأية لغة كان يتكلم: العربية أم العبرية أم الآرامية؟ بالطبع إن الله على كل شيء قدير، ولكن لماذا على الله أن يخالف القوانين الفيزيائية التي أرساها لينظم حركة الكون؟! هذه أسئلة تحتاج إلى أجوبة لكي نفهم كيف يمكن أن يكون العرب والعبرانيون والآراميون من جد واحد!؟
فوضى دينية وديانة جديدة
من رحم هذه الفوضى الدينية والمذهبية المشرقية، أطلَقَتْ الإمبرياليةُ الغربية الديانةَ الإبراهيمية الجديدة اعتماداً على المشتركات بين الأديان الثلاثة، وهي مشتركات إنسانية ما قبل إبراهيمية، تعتمد على جملة المحرمات الأخلاقية التي كان يعاقب مرتكبها في الشرائع القديمة (لا تكذب لا تقتل لا تسرق لا تزن لا تهزأ بإله غيرك..).
يمكن القول إنّ الماسون هم أول من استخدم الرموز والمصطلحات الإبراهيمية في استقطاب النخب العالمية واستثمارها، بينما يرى الباحث رضوان السيد في كتابه “الديانات الإبراهيمية من الاختلاف إلى الائتلاف” أن تسمية الديانات الإبراهيمية نشأت على يد بعض الدعاة الكاثوليك في خمسينيات القرن الماضي، وترسخت التسمية في مجمع الفاتيكان أوائل الستينيات وذلك على أساس أنّ الاتفاق في عددٍ من الأصول، ومنها الأصل الإبراهيمي، كفيل بتسهيل الحوار وفتحه وإيصاله إلى أُفُقٍ يخدم السلام بين الأديان والسلام في العالم، حيث تمت دعوة المسلمين واليهود للقاء تحت لواء الإبراهيمية الظاهرة في الديانات الثلاث. هذه المبادرة لاقت صداها الإيجابي بين بعض المسلمين، لأنها في الأصل هي دعوة القرآن الكريم حيث تقول الآية 64 من سورة آل عمران:
“قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله”. كما أنها مترسخة في رؤية العرب والمسلمين التاريخية، وأيضاً في ممارساتهم التعبدية عبر فريضة الحجّ إلى البيت العتيق الذي بناه إبراهيم وابنه إسماعيل. فالمسلمون استناداً إلى المنطق القرآني إنما يطلبون الشراكة في الميراث الإبراهيمي.
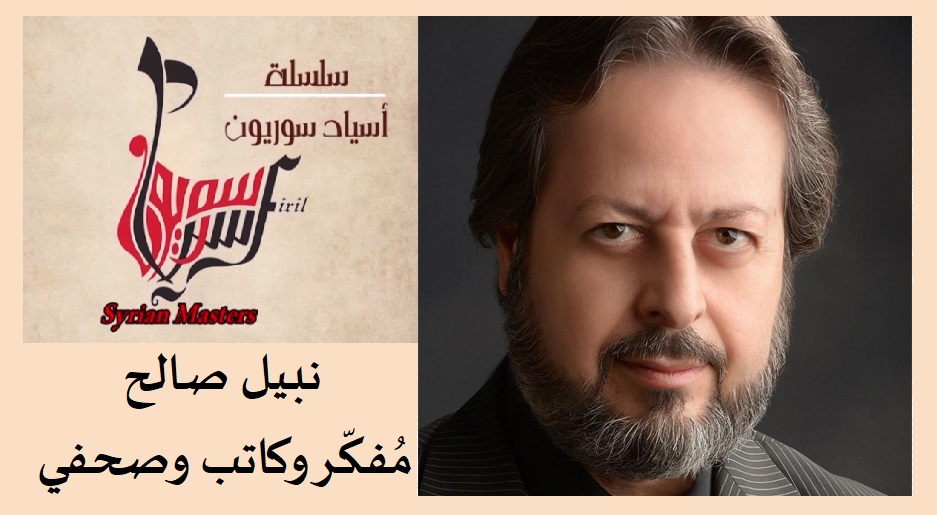
أما بخصوص اليهود فكانت المشكلة معهم أنهم أقفلوا الدعوة الإبراهيميّة التوحيديّة عليهم، ورفضوا الدعوتين الجديدتين: المسيحيّة والإسلاميّة. فهم يرون أنه لا نبوة ولا كتاب إلّا ما قالوا به هم، وانتسب إليهم، بما في ذلك الانفراد بأنهم أولياء الله وأحباؤه. ثم وفي القرنين السابع والثامن للميلاد ظهر القراؤون الذين أرادوا استحداث تأويل جديدٍ للتوراة متأثرين في ذلك بما كان يحدث داخل المسيحيّة؛ بل وكانوا يرون أنّ الإسلام ليس إلّا انشقاقاً في المسيحيّة أو فرقة جديدة فيها. وأمّا المسيحيون بِفرَقهم الثلاث الرئيسة (الملكية واليعقوبية والنسطورية)، فإنهم أطلقوا على الإسلام اسم “الهاجرية، باعتباره انشقاقاً أو هرطقة قام بها الجنس العربي ليحولوا دون استمرار المسيحيّة في الانتشار بين العرب. وهناك الكثير من الروايات عن جدال وحواراتٍ بين المسيحيين والمسلمين في القرنين الأول والثاني للهجرة والثامن والتاسع للميلاد يذكرها عادل تيودور خوري في أُطروحته عن “الجدالات البيزنطية ضدّ الإسلام”: فعلى الرغم من العلاقات الإنسانيّة الطيبة بين الطرفين لم يخفّ أو يتضاءل الخلاف العَقَدي، بل تزايد في زمن القرآن والصحابة، حيث أراد المسلمون جمع أهل الديانات الثلاث تحت لواء الإبراهيمية التي حدد القرآن مبادئها في إعلان (الكلمة السواء). لكن المثقفين المسيحيين كانوا يخوضون في تفصيلاتٍ لا تنتهي عن أصول الإسلام، والتي تجعل من غير الممكن انتماؤه إلى الميراث الإبراهيمي. ومن ضمن تلك التفصيلات قَصص ورقة بن نوفل وبَحيرا الراهب والتناقُضات داخل النصّ الإسلامي.
رد المثقفون المسلمون عليهم كما في رسالة الجاحظ في الردّ على النصارى، ورسائل الكندي الفيلسوف والقاسم بن إبراهيم والطبري. ثم كتابات أبي عيسى الورّاق في الردّ على الفِرَق المسيحية الثلاث. يرجح السيد أنّ المعتزلة هم الذين بدؤوا هذه الردود، حيث تتضمن أربع موضوعات رئيسة: المسائل المتعلقة بطبيعة المسيح وأسرار تلك الطبيعة بحسب الفِرَق المسيحية المتصارعة حولها، والمسائل المتعلقة بالأقانيم وأنها ليست هي الصفات التي عرفها علم التوحيد الإسلامي. والمسائل المتعلقة برواية الكتب المقدّسة وبخاصةٍ الأناجيل. والمسائل المتعلقة بالحياة الدينية ونظام الكهنوت لدى المسيحيين. ففي نظر المسلمين كاتبي الردود؛ فإنّ ذلك كله يوحي بالخروج على الوحدانيّة، وعلى طبيعة الإنسان التي تأبى تلك الأسْطرة المعقدة بوصفها ديناً. ولم يقصر المفكرون المسيحيون في ردودهم على الدعاوى الإسلامية وانتقادهم لتعاليم القرآن وطرائق جمعه ونقله: فانتقدوا جبروت دولة الإسلام، واختلاط الدين بالسلطة في الشرعنة والتسويغ. وقد كانوا حذرين بشأن الوحي والنبوة؛ لكنّ أقصى ما كان أحدهم مستعداً للتنازل من خلاله للمسلمين هو القول: إنّ محمداً سار في طريق الأنبياء، فقد ظل الطابعُ الغالب على ردودهم الدفاعَ دون الهجوم. وعلى امتداد ثمانمائة عام لم يخبُ الجدال ولم يتراجع. وقد كان هؤلاء العلماء من الطرفين مؤدبين في التعامل بعضهم مع بعض في المجالس العلمية التي كانت تنعقد في القرنين الرابع والخامس للهجرة.في زمن الاستعمار الأوروبي غابت ثقافة الدفاع عن المشترك الإبراهيمي بين الطرفين، وكان كثيرٌ من مثقفي المسلمين بما فيهم العلمانيين يرون أن الاستعمار يحمل عِرقاً مسيحياً ظاهراً، ويشجع على التبشير.
الدين الإبراهيمي الجديد في الشرق الأوسط. مركز فيريل للدراسات. الكاتب والمُفكّر نبيل صالح 24.09.2021. ومثلما كان بعض المجادلين المسلمين في العصور الوسطى يسوقون قوة الدولة الإسلاميّة من ضمن أدلة صحة الإسلام؛ فإنه في زمن الاستعمار الأوروبي صار بعض المجادلين الغربيين يسوقون التقدم الغربي دليلاً على صحة المسيحية وانتصارها على الإسلام المتراجع أمامها. ثم ومنذ مطالع الخمسينات من القرن الماضي، انطلقت دعواتٌ للحوار مع المسلمين من جانب الكنائس البروتستانتية، ومن جانب مفكرين كاثوليك ومستشرقين، وكانت لها دوافع سياسيةٌ مندغمة مع الحرب الباردة ضد المعسكر الشيوعي، حيث تحالفت الكنائس الغربية الوطنية مع بلدانها في عمليات الصراع على العالم، ومن ذلك عالم المسلمين.
وهكذا انعقدت منتديات الحوار الأولى في لبنان ثم باكستان بوصفهما من حلفاء الولايات المتحدة، وحدثت فيها جدالاتٌ غير دينية مثل قضية فلسطين وقضية كشمير، ومناهضة الاستعمار. لكنْ تلك المنتديات كسرت الجليد، وركزت على الاشتراك في الإيمان بالإله الواحد، والدوافع الأخلاقية، لتعود الأطُروحة الإبراهيميّة للبروز من جانب مفكرين ومستشرقين كاثوليك عبر مجمع الڤاتيكان الثاني كما سبق القول. 5 هجوم 11 أيلول 2001 الذي قامت به مجموعة إسلامية سلفية بزعم الدّفاع عن المجتمع الإسلامي، دفع بالحكومة الأمريكيّة إلى إعادة النّظر في تدخل دبلوماسيّيها بقضايا دينيّة، وراح السياسيون العلمانيون في واشنطن يراجعون مواقفهم بمن فيهم وزيرة الخارجية الشريرة مادلين أولبرايت (يهودية تشيكية)، حيث تقول: “يسعى العديد من ممارسي السّياسة الخارجيّة – بمن فيهم أنا – إلى فصل الدّين عن العالم السّياسيّ لتحرير المنطق من المعتقدات.
عندما كانت الولايات المتحدة تتعامل مع قضايا السياسة الخارجية الخاصة بالشرق الأوسط، أدركت أنه إذا كانت القُـدس مُـجرّد قضية أرض متنازَع على مـلكيتها، لكان بإمكاننا حلّـها منذ سنوات طويلة، ولكن الواقع هو أن أطراف النِّـزاع يُـؤمنون بأنها أرض ومقدّسات أعطاها الله لهم، ولذلك، أصبح لقضية القُـدس أبعاد مختلفة تماماً، وهكذا اتَّـضح لي أكثر فأكثر أن كثيراً من الصراعات التي أعقبت الحرب الباردة، كانت لها علاقة بالدِّين، ولذلك أصبح يتعيّـن على المهتمِّـين بشؤون السياسة الخارجية أن يتفهّـموا دور الدِّين كقُـوة في قضايا السياسة الخارجية وكيفية استخدام البُعد الديني في العـثور على العناصر التي تجمّـع بين أطراف النزاع، وإذا درَس المرء الدّيانات الإبراهيمية الثلاث، سيجد فيها مفاهِـيم مُـشتركة عن السلام والعدل والخير”..
مع بداية الألفية الثالثة ازداد الانخراط بين الدبلوماسيّة والدّين في علاقات الولايات المتّحدة الأمريكيّة بالعالم الإسلامي. وتم تبني الدّعوة الأوروبية بخصوص الديانات الإبراهيمية، ولكن لأسباب غير دينية، بغية دعم مفاوضات السّلام الجديدة في الشرق الأوسط حيث يلعب القادة الروحيّون دوراً رائداً في مجتمعاتهم في تشكيل مواقف الأفراد من السياسات المحلية والدولية. في عام 2002 وباقتراح من الملك الأردني عبد الله بن الحسين قام معهد “بروكنغز” بإنشاء “مركز صبان” للأبحاث المتعمقة والبرامج المبتكرة لتعزيز أفضل إدراك للخيارات السياسية لصناع القرار الأمريكي في الشرق الأوسط.”. سمي المعهد على اسم اليهودي الثري حاييم صبان، أكبر متبرع للحملات الانتخابية في أمريكا للحزبين الديمقراطي والجمهوري وكذلك حزب العمل الإسرائيلي، حيث تبرع بمبلغ 13 مليون دولار لصالح تأسيس المركز وأكمل الباقي أمير قطر حمد بن خليفة.ويتوزع نشاط مركز حاييم صبان بين ثلاث مكاتب في واشنطن وتل أبيب والدوحة وأسسه اليهودي مارتن إندك سفير الولايات المتحدة في إسرائيل لمرتين، ونائب مدير أبحاث لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (آيپاك)، كما يذكر أنه كان متطوعاً في كيبوتس إسرائيلي أثناء حرب تشرين 1973، وقد ضم المركز نخبة من الباحثين اليهود والمسلمين الأمريكيين. ومنذ سنة 2004 يقيم المركز مؤتمرات سنوية حيث حضر مؤتمره الأول أكثر من 165 مشاركاً من الولايات المتحدة و37 دولة إسلامية من السنغال إلى إندونيسيا، من بينهم زعيم إخونج تونس راشد الغنوشي والإخونجي المصري يوسف القرضاوي والرئيس الأفغاني حميد كرزاي والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامية الإخونجي التركي إكمال الدين إحسان أوغلو، والصادق المهدي زعيم حزب الأمة الإسلامي، وزعيم حزب العدالة الإخونجي رجب طيب أردوغان، وكبار شيوخ المؤسسة الوهابية السعودية، ووكيل الأزهر عباس شومان. ومنذ سنة 2005 يعزز المركز حواره مع الشخصيات الإخونجية الذين رحبوا بالاستراتيجية الأمريكية الجديدة تجاههم، ووجدوا أنفسهم مرة أخرى أمام خيار محاصرة الأنظمة العلمانية، والانخراط في لعبة المصالح الدولية، إلى أن نضجت خطة الربيع الإخونجي سنة 2008 أثناء انعقاد مؤتمر المركز السنوي في إسرائيل. وكان يفترض أن يحكم الإخونج المؤيدون للتوجه الإبراهيمي في بلدان الربيع العربي، وما زلنا نذكر فضيحة مراسلات الرئيس مرسي مع شمعون بيريز.جدير بالذكر أن معهد صبان قد استضاف في تموز ٢٠١٣، الشيخ راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة التونسيّة، وألقى الغنوشي خطابه في المركز محاطاً بترحيب حار، كما أقام المركز في العام ذاته في واشنطن حفلَ تكريم للشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطريّ السابق ومنسق أعمال الربيع العربي بين واشنطن والإخونج.كذلك يتم توظيف الدين في السياسة من قبل مدعي العلمانية عبر “مؤتمرات حوارات الأديان” حيث تستخدم القوى الناعمة في حسم الصراعات، وضمان أفضل النتائج من دون تكبد خسائر مادية ودفع فاتورة حروب باهظة الثمن.
استخدم الأمريكان في ثمانينات القرن الماضي الديبلوماسية الدينية كجزء من خطة تفكيك الاتحاد السوفياتي، وهم يستخدمون هذه الديبلوماسية منذ بداية الألفية الثالثة لتفكيك القضية الفلسطينية، وتمييع الصراع على القدس، من خلال استغلال فكرة الفاتيكان الإبراهيمية التي كان يهدف منها إلى تفكيك الألغام الدينية التاريخية وتحقيق السلام، بينما تقوم ديبلوماسية واشنطن على النقيض منها. ومنذ سنة 2013 تم إنشاء فريق عمل حول الدين والسياسة في وزارة الخارجية بقرار من “هيلاري كلينتون”، يضم 100 عضو أغلبهم رجال دين من الديانات الثلاث يعملون إلى جانب الدبلوماسيين بالوزارة، ولا يزال هذا الفريق قائمًا حتى الآن.ومن أكثر الناشطين ضد المشروع الإبراهيمي الدكتورة المصرية هبة جمال الدين أستاذة العلوم السياسية والدراسات المستقبلية بمعهد التخطيط القومي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، وإن غلب على نشاطها الإثارة الإعلامية التي تضعف الرؤية الموضوعية في استشراف الحدث، حيث تقول أن القادة الروحيين، وخصوصا الصوفيين، هم من الأدوات المهمة لقيام المشروع الإبراهيمي وجذب المريدين والمؤمنين بالفكرة، حيث يتم اختيارهم بناء على معايير كثيرة، أهمها تمتعهم بالتأثير الفعلي داخل مجتمعاتهم، حيث يتم نشر الأفكار والحوار بشأنها عبر تقديم خدمات تنموية على الأرض بهدف مكافحة الفقر في العالم وخلق دخلٍ للأسر الفقيرة لتصبح من أصدقاء السلام العالمي. وقد تم ربط هذه الفكرة بأهداف التنمية المستدامة باعتبارها تهدف أيضا لمكافحة الفقر العالمي عبر الحوار الخدمي، حيث تم تفعيل السياحة الدينية المشتركة، باعتبار أن دول المنطقة جميعها تضم مقدسات دينية تاريخية، وتعاني – في الوقت ذاته – من مشاكل اقتصادية تحتاج لتنشيط مصدر جديد يدر الدخل.
بالإضافة إلى مشروعات ريادة الأعمال التي تمثل مصدر دخل للأسر الفقيرة، وتحظى بقبول مجتمعي، بالنظر إلى مساهمتها في مكافحة الفقر. كما يتم التركيز على شريحة الشباب المسلم باعتبارهم أساس الحركة المجتمعية، حيث يتم تدريبهم مع غيرهم من أتباع الأديان الإبراهيمية لكسر جدار العزلة والوصول إلى طقوس دينية جديدة تدمج بين الأديان الثلاثة، ومن ثم يتم استخدامهم في التبشير بين مجتمعاتهم لإقناعهم بتطبيقها داخل دور العبادة.ويتوفر للمشروع الإبراهيمي عدد من الكيانات العلمية الداعمة للفكرة، كالجامعات الدولية، وفي مقدمتها جامعة هارفارد ومشروعها الذي يرصد رحلة النبي إبراهيم بين عشر دول ليرسخ الفكرة الإبراهيمية بين الدول المختلفة. بالإضافة إلى استغلال المحافل الدولية التي تمثل تطبيقاً عملياً، كالمؤتمر السنوي لمركز الصبان في قطر كما ذكرنا، ومؤتمر دافوس الذي تُعقد على هامشه لجنة المائة التي تهدف بدورها إلى الوصول للمشترك الإبراهيمي والتقارب بين القيادات الروحية والسياسية لتوفير كل سبل الدعم الممكن.وبالطبع فإن ذلك سوف يستدعي إعادة قراءة النصوص الدينية، واستخدامها بما يؤكد النهج السياسي للدول والمؤسسات الراعية للمشروع. وقد رأينا فيديوهات للعديد من المطبعين السعوديين والخليجيين يعيدون فيها استخدام “الإسرائيليات” الواردة في القرآن الكريم لتأكيد التطبيع، حيث يزخر القرآن الكريم بالحديث عن بني إسرائيل الذين فضلهم الرب على العالمين!!
احتضان الدين الإبراهيمي الجديد
كما تحتضن قطر الدعوة الإبراهيمية، فهي تحتضن أيضاً دعاة التطرف الإسلامي وفي مقدمتهم سفراء طالبان والقاعدة وجبهة النصرة، حيث تتلاعب بالمتناقضات الدولية ببراعة سياسية قل نظيرها في العالم العربي، حتى لتبدو فقاعة الغاز القطري أقوى من الأنظمة العربية جميعا؛ ففي 11 شباط الماضي نظم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يتخذ من العاصمة القطرية الدوحة مقراً له مؤتمرا بعنوان “موقف الأمة الإسلامية من الديانة الإبراهيمية”، عارض المتحدثون فيه بشدة مبادرات السلام والتسامح التي ترتكز على المشتركات بين أتباع الديانات الإبراهيمية الثلاث، واعتبروها دعوة لتأسيس ديانة جديدة بهدف الترويج للتطبيع مع دولة إسرائيل. وبحسب نص البيان الختامي للمؤتمر، فقد اعتبر المؤتمرون “فكرة الدين الإبراهيمي” الذي “يقوم على المشترك بين عقيدة الإسلام وغيره من العقائد فكرة باطلة”، وأن “الزعم بأن إبراهيم عليه السلام على دين جامع للإسلام واليهودية والنصرانية- زعم باطل، ومعتقد فاسد”.من جانبه، لم يتأخر تنظيم “داعش” في إعلان موقفه الرافض للسلام والتسامح مع اليهود والمسيحيين، وأورد حججاً وعبارات مماثلة لتلك التي ساقها مشايخ الاتحاد في بيانهم، حيث قال بأن النبي إبراهيم كان يدين بالإسلام، ونفى أن تكون له أي علاقة باليهودية أو المسيحية اللتين اعتبرهما التنظيم “أدياناً باطلة”.ذلك أن تحشيد المتطرفين سوف يدفع بالمعتدلين إلى أحضان الأمريكيين والإسرائيليين بدلاً من بقائهم على خط الحياد العلماني، وبالتالي سوف يتم تحويل جزء من العداء لإسرائيل إلى ساحات أخرى منها العداء للعلمانية والقومية العربية، ولإيران عدوة الجميع بالطبع. العالم يتغير، فهناك أخلاق جديدة وأمراض جديدة واقتصادات جديدة وشركات عابرة للأديان والجنسيات وأفراد يعبدون أجسادهم ويحرصون على استقلاليتهم، وهم جاهزون لاستقبال أفكار وأيديولوجيات وأخلاقيات جديدة يتم فيها تحطيم الأشكال والأنساق القديمة، إذ يتواصل الفرد العالمي اليوم مع الخارج أكثر مما يتواصل مع عائلته، وحيث توفر له التكنولوجيا والإنترنيت والعملة الرقمية طريقة عمل جديدة واقتصاداً مختلفاً يحتاج إلى ديانة إلكترونية افتراضية تحل بديلاً عن الرب الذي عبده آباؤنا وأجدادنا. ذلك “أن الإنسان لربه لكنود وإنه لحبّ الخير لشديد”. صدق الله العظيم. الكاتب والمفكر نبيل صالح. 24.09.2021 Firil Center For Studies. Berlin. Germany